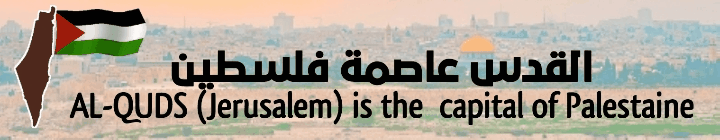ماذا يجري في الجنوب؟
سؤالٌ مُلِحّ في مرحلةٍ عصيبة تشهد فيها منطقتُنا صراعًا محتدمًا بين مشروعٍ وطنيٍّ وقوميٍّ وإسلاميٍّ يحاول الدفاع عن ذاته، وبين مشروعٍ صهيونيٍّ يسعى إلى تفتيت العرب وإزالة مقوّمات وحدتهم، وضرب هويتهم القومية وعقيدتهم، ودفعهم نحو صراعٍ طويل الأمد لا يخلّف سوى الخراب والدمار والفقر والجوع. صراعٌ غايته النهاية الحتمية: موت القيم والمبادئ والأخلاق التي تربّى عليها الإنسان ونشأ في ظلها، والتي تكبر معه كلما كبر، فيما يُراد له اليوم أن يتخلّى عنها ليغدو إنسانًا بلا هوية ولا حضارة ولا إرث ولا قيم ولا أخلاق؛ مجرد كائنٍ نفعيٍّ وصوليٍّ أنانيٍّ يبيع شرفه وعِرضه ووطنه.
قد نختلف؛ والاختلاف نعمة لا نقمة، شريطة أن يكون اختلافًا واعيًا يصنعُ إنسانًا حقيقيًا. فالإنسان الحقيقيّ يدافع عن أخيه الإنسان، وعن رأيه وفكره ومشروعه السياسي. أمّا حين يفقد المرء إنسانيته فإنه يتحول إلى كائنٍ تحرّكه الغرائز، يفجّر في الخصومة، ويفرض نفسه حاكمًا وجلادًا في الوقت ذاته. فالحيوان الأليف ينقاد لمن يشبعه بالقليل ويوجّهه ليكون شرسًا تجاه من لا يرضى عنه سيّده، وما أكثر أمثال هؤلاء بيننا.
تقاتلنا ولم نحصد غير الأحقاد والضغائن والثارات، وسنتقاتل—إن استمر الحال—ولن نجني سوى مزيدٍ من التراكمات التي تمزقنا وتشتت أوصالنا. ففي الحروب الأهلية لا يوجد منتصر ومهزوم؛ الجميع مهزوم، لأن الهزيمة الحقيقية هي هزيمة الوطن. فعندما تنكسر لحمة الأمة وتماسكها وروابطها الاجتماعية، ويتفتت النسيج الاجتماعي وتنهشه الشروخ، فما الذي يبقى من وطنٍ يعاني مجتمعُه التمزق والانقسام؟
السؤال الذي ينبغي أن يشغل أذهاننا اليوم هو: مَن هو محرّك هذا العنف، وصاحب قرار هذه الصراعات والحروب؟ وماذا يُراد لنا أن نكون؟
لو كان في الأمر خير، لكانت المناطق المحررة خير شاهد. وعدن—بواقعها المزري والمخزي—تكفي وحدها لتحريك الضمائر، ولإعادتنا إلى جادة الصواب، واستعادة رشدنا، والاهتداء إلى ما يجمعنا ويخدم وطنًا يسعنا جميعًا دون إقصاء أو تهميش أو عنف أو صراعات أو حروب.
والله الموفِّق.